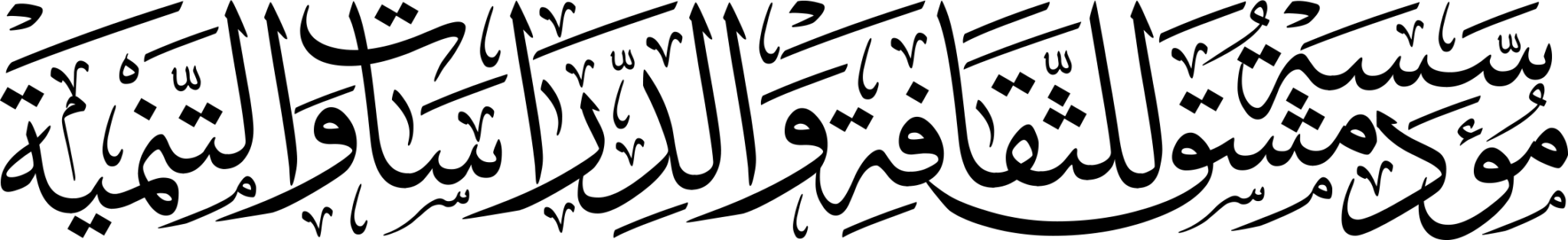بعد سلسلة من 12 مقالة ضمن ملف “لحظات سوريا الفارقة…قبل الأسد”، هنا الحلقة الثالثة عشرة عن سوريا الأربعينات والخمسينات من القرن العشرين، والتي خرجت من مرحلة الانتداب الفرنسي لتتعثر بالانقلابات العسكرية في طريق بناء استقلالها المستجد.
بقلم: إبراهيم الجبين
كما قد يختلف الذين أسقطوا بشار الأسد في 8 من كانون الأول/ ديسمبر 2024 على مستقبل سوريا، اختلف الذين أسقطوا أديب الشيشكلي في 26 شباط/ فبراير 1954، بعد وقت قصير من وصولهم إلى السلطة، إثر إعلان رئيس الأركان شوكت شقير تسليم الحكم للرئيس هاشم الأتاسي، وعودة الحياة الدستورية بالمجلس النيابي ذاته الذي شكّل قبل انقلاب الشيشكلي. وما كان يعرف بـ “ميثاق حمص” الذي توافقت عليه القوى والشخصيات الوطنية لم يصمد طويلاً، فقد تم تشكيل حكومة جديدة في مطلع آذار/مارس عام 1954 بتكليف من الأتاسي لصبري العسلي وكان هدفه توحيد كلمة الأحزاب الوطنية التي كانت ضد تفرّد الشيشكلي بالحكم. وهكذا أسست الحكومة الجديدة بالتعاون مع حزب الشعب، على الرغم من تباين مواقف العسلي وهذا الحزب في الكثير من القضايا. وكان برنامج الحكومة الأساسي يركّز على الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد عودة الحياة الدستورية، إلا أن الصراعات عادة، بمواجهة بين العسلي وضباط الجيش، وقد كانت خطة العسلي تطهير المؤسسة العسكرية من عناصر الشيشكلي (فلول نظامه).
قتل الآباء
تم اتهام العسلي بالعمالة للأميركيين، بعدما التقى الجنرال الأميركي آرثر ترودو، مساعد رئيس أركان الجيش الأمريكي، بدمشق في 9 أيار/مايو 1954، بحضور وزيري الخارجية والدفاع لبحث استعداد الولايات المتحدة تزويد سوريا بأسلحة ومعدات حربية مقابل شروط سياسية، حيث أبدى ترودو استعداد بلاده لذلك خلال اجتماعه مع المسؤولين السوريين، فسقطت حكومته. ولاستكمال الإشراف على الانتخابات كلّف الرئيس الأتاسي سعيد الغزي تشكيل حكومة جديدة، وهذا الرجل يعتبر أباً من الآباء الدستوريين السوريين الكبار، بعد مشاركته في إعداد دستور العام 1928، وهذا الاعتبار المبدئي منعه من الموافقة على انقلابات حسني الزعيم، وسامي الحناوي، وأديب الشيشكلي، حيث قضى تلك السنوات مبتعداً عن السياسية ومتفرغاً لمزاولة مهنته في المحاماة من مكتبه الشهير في ساحة المرجة، ولم يعد إلا حين طلب منه الرئيس هاشم الأتاسي.
نُظمت انتخابات نيابية في أيلول/سبتمبر عام 1954 للدور التشريعي السادس، وكانت نتائجها تظهر التحول في توجهات السوريين آنذاك، فقد فاز حزب الشعب بـ 30 مقعداً وتلاه الحزب الوطني بـ 19 مقعداً وحزب البعث بـ 22، فيما فاز الحزب الإخوان المسلمون بـ 4 مقاعد فقط، والقوميون السوريون بمقعدين والحزب الشيوعي بمقعد واحد. وكانت المفاجأة هي فوز المستقلين بـ60 مقعداً. ونتائج تلك الانتخابات ظهرت هكذا بسبب مناخ الحريات الذي أصرّ عليه سعيد الغزي، مناخ فتح الباب أيضاً أمام قادة ميدانيين مثل أكرم الحوراني ورفاقه للتبشير بأفكار البعث في القرى والبلدات بشكل واسع، وتحريض العمال والفلاحين على الملاكين والطبقات العليا في المجتمع، وعلى إثرها تشكّلت حكومة برئاسة فارس الخوري، وكان البعث، آنذاك، يعيش أفضل أيامه على مستوى الانتشار الشعبي، وبدأت أفكاره تلقى قبولاً واسعاً لدي السوريين، بينما شهد في داخل بنيته التنظيمية تناقضات غير مسبوقة، على مستوى علاقة قياداته وكوادره بإيديولوجيا الحزب ذاتها، فدارت جدالات حادة بين البعثيين حول معنى الوحدة والحرية والاشتراكية، وكثرت الخلافات التي رآها بعض كبار البعثيين تحطيماً لأصول النقاش السياسي القائم على الاحترام، وهكذا انشطر البعث عمودياً وأفقياً إلى أربع كتل؛ الكتلة البعثية، الكتلة الاشتراكية، الكتلة المدنية والكتلة العسكرية. وقد وصف ذلك بمرارة الوزير سامي الجندي في كتابه “البعث” الصادر عن دار النهار في بيروت العام 1969.

التدخل الإسرائيلي في واقع سوريا الهش لم يكن يتوقف حينها، فلم يكد يُعلَن مجلسٌ نيابي وحكومة جديدان، حتى فاجأت إسرائيل السوريين باختطاف طائرة مدنية سورية وإجبارها على الهبوط في مطار اللد، مطالبة باعتبار ركابها رهائن تجب مبادلتهم بخمسة إسرائيليين تسللوا إلى سوريا وتم توقيفهم في دمشق. ذلك الضغط الإسرائيلي كان بمثابة وخز مستمر في الوجدان الشعبي السوري الذي أخذ يستقبل الخطاب القومي العربي بترحيب أكبر، وأدى انتشار فكر البعث في الشارع السوري إلى تعزيز وعي قومي جديد في سوريا، مع عودة البضاعة القومية هذه المرة عبر خطاب جمال عبد الناصر الذي كرّسته اتفاقية جلاء القوات البريطانية عن مصر، حتى تلك اللحظة بدا نظام الضباط الأحرار في مصر موالياً للغرب، حتى إن واشنطن ولندن ضغطتا على البنك الدولي لدعم مصر وتمويل مشروع السد العالي في أسوان لتنمية البلاد.
وأخذت منطقة استراتيجية في الشرق الأوسط تلعب دوراً في تأجيج الصراع، هي قناة السويس التي مكّنت عبد الناصر من الضغط على الإسرائيليين، ضغوط يعلل بها بعض مؤرخي تلك المدّة ارتفاع حاجة الإسرائيليين إلى تعزيز قدراتهم العسكرية وتوجههم نحو فرنسا، بينما اتجه عبد الناصر نحو الأميركيين والبريطانيين لطلب تسليح الجيش المصري. ولمّا رُفض طلب مصر، ردّ عبد الناصر، ومعه السوريون، بشراء السلاح من المعسكر الشرقي، وهكذا أخذ تموضع مصر ينزاح نحو الكود الشرقي أكثر، ساحباً معه سوريا. ومع أن المتوقع من الأميركيين رفض ذلك الانزياح، إلا أنهم عزّزوا تفاهمات مصر وسوريا، لتشكيل قوة ثالثة بين المعسكرين الشرقي والغربي ستكون المؤتمر الأفرو آسيوي ودول عدم الانحياز.
على مستوى أداء الحكومة، استكملت الإدارة السورية استملاك البنى التحتية وخطوط القطارات في عموم الأراضي السورية، بعد شراء الحكومة لامتياز شركة الخط الحديد الفرنسية. وفي الوقت ذاته، كانت شخصية رئيسها فارس الخوري تضيق ذرعاً بالانشغال بالهموم الداخلية، وهو الذي بات يحتل مكانة دولية بعد إسهامه في تأسيس الأمم المتحدة في نيويورك ودوره البارز في إرساء دعائمها.
عانى الخوري من معارضة البعثيين لحكومته، فقد رفضوا المشاركة فيها رغم فوزهم في الانتخابات، وشاركهم في هذا الموقف خالد العظم وكتلة المستقلين الكبيرة، فلم يجد أمامه سوى كتلة حزب الشعب الموالي للعراق، والحزب الوطني ومن خلفه شكري القوتلي الذي كان حتى ذلك الحين يقيم في مصر. وهكذا باتت الحكومة السورية مشتتة الولاء بين الهاشميين في العراق وبين عبدالناصر. وزاد من تعقيد موقف حكومة الخوري، ظهور حلف بغداد، وهو محور أسسته ودعمته الولايات المتحدة ويمتد من تركيا والعراق حتى إيران والباكستان، ووعدت دوله بعهد جديد قائم على التنمية والازدهار، وكانت القوى الفاعلة فيه ترى أن على سوريا الانضمام إليه، الأمر الذي رفضه الخوري معتبراً أن الحياد هو الخيار الأفضل لبلاده. لكن رفض الخوري لم يشفع له عند عبدالناصر الذي ألح عليه كي يدين حلف بغداد بشكل صريح. فلم يقبل، وكانت عقوبته حملة عنيفة شنها عليه البعثيون في سوريا متهمينه بالعمالة لمصلحة رئيس الحكومة العراقية نوري السعيد، وأخرجوا ضدّه مظاهرات شعبية نالت من أمانته.أراد الخوري لعب دور إيجابي في الساحة العربية، من دون الوقوع في الاستقطاب، فتوسّط لدى عبدالناصر في قضية الإخوان المسلمين بعد حادثة المنشية ومحاولة اغتيال عبدالناصر، وقدّم نفسه والحكومة السورية والشعب السوري كضمانة في أي مصالحة يمكن أن يجريها عبد الناصر معهم، إلا أن الأخير رفض هذه الوساطة وأصر على محكامتهم عسكرياً وصدرت أحكام مختلفة بالسجن المؤبد والإعدام، فكان لتلك الخيبة أثر كبير في الخوري الذي قرّر بعدها الاستقالة من منصبه في 7 شباط/فبراير1955 والاعتكاف في منزله واعتزال العمل السياسي إلى الأبد.

ويمكن تتبع دوافع عملية اغتيال المالكي في برقية أرسلها وزير الخارجية الأميركي جون فوستر دالاس، للسفير الأميركي في العراق فالديمار غاكمان، قال فيها إن “استيلاء عدنان المالكي أو ضباط يساريين على السلطة، وعقد معاهدة مع عبد الناصر يمكن أن يقود إلى سياسات سورية معادية للغرب وهو ما قد يقدح شرارة عمل عسكري عراقي أو حتى احتمالاً أسوأ يتمثل في عمل عسكري إسرائيلي ضد دولة عربية أو حتى أكثر من دولة”، وفقاً لدوغلاس ليتل، أستاذ التاريخ في جامعة كلارك بمدينة وورشستر الأميركية، الذي كتب في دورية “ميدل إيست جورنال” مطلع التسعينيات إن ضابط ارتباط CIA في دمشق ستيفن ميد كان يعمل من أجل “دراسة إمكانية إقامة ديكتاتورية مدعومة من الجيش”.
وقد أعادت مزاعم الاعتداء على تمثال عدنان المالكي في دمشق في آذار/مارس الماضي من هذا العام، الاهتمام الشعبي بسيرته، بعدما كان، وعلى مدى عقود رمزاً غير مفهوم بالنسبة لكثير من السوريين والعرب، وظن كثيرون أن اهتمام البعثيين به يعود إلى كونه أيقونة من أيقوناتهم، وكثيراً ما كان قادة نظام الأسد يستخدمون تمثال المالكي لإرسال رسائل مهينة لخصومهم، كما عُرف عن عبد الحليم خدام نائب رئيس الجمهورية الأسبق أنه كان يصرّ على الطلب من أي وفد رسمي لبناني رفيع المستوى الطواف حول تمثال المالكي مرات عديدة قبل القدوم إلى الاجتماع معه في مكتبه بدمشق، كي يذكّر اللبانيين بقدرة النظام السوري على البطش في أي وقت بأقوى التيارات التي أنجبها لبنان، مثلما فعل مع الحزب السوري القومي الاجتماعي.

حالة الاحتقان المحلية والدولية تلك، جعلت حكومة العسلي في حالة ترنّح، وكان اغتيال المالكي عاملاً حاسماً في رفض الشارع والطبقة السياسية لتوجهاته، فاضطر إلى إعلان مواقف مناوئة للغرب، واتهم الأميركيين بتدبير اغتيال المالكي، وأصدر أمراً بحلّ الحزب السوري القومي الاجتماعي وباعتقال قياداته وأعضائه. وفي تلك اللحظات أصدر العسلي قراراً سيغير وجه سوريا، حين عيّن عبد الحميد السراج رئيساً للمكتب الثاني وباتت شعبة المخابرات العسكرية تحت إمرته، لتعيش حكومة العسلي على ذلك الحال ثلاثة أشهر فقط ثم تنهار.
انزياح صورة الزعيم
لم يكن نموذج عبد الناصر يروق للنخبة السياسية السورية التقليدية. وشأنه شأن الخوري، كان الرئيس الأتاسي يرى أن عبد الناصر غير جدير بقيادة الأمة العربية، ولذلك قام بالتضييق على مؤيديه في عموم سوريا، معلناً صراحةً أنهم يريدون تحويل سوريا “إلى قمر اصطناعي مصري”، وعلى عكس الخوري أراد الأتاسي زج سوريا بقوة في حلف بغداد، وهذا الموقف فاقم من صدامه مع الضباط البعثيين والناصريين في الجيش السوري، وبلغ التناقض بينه وبين عبد الناصر أنه كلّف الخوري ذات مرة بزيارة مصر والاحتجاج رسمياً على ما سماها “هيمنة عبد الناصر على الشؤون العربية”. كان الأتاسي يشعر بالخيانة بسبب تأييد بعض أفراد أسرته لعبدالناصر، وبينهم ابنه عدنان ونور الدين الأتاسي، وقد ظهرت صلابة موقفه هذا حين رفض زيارة عدنان في السجن بعد توجيه الاتهام إليه بالتآمر لمصلحة عبد الناصر، بعد سنوات، وقبلها انتظر الرئيس الأتاسي حتى انتهت ولايته الدستورية في أيلول/ سبتمبر عام 1955 ثم لحق بدرب رفيقه الخوري، واعتزل الحياة السياسية واعتكف في داره بحمص بعدما ناهز الثمانين من العمر.
كان واضحاً أن البعث بات يهيمن شيئاً فشيئاً على المشهد السوري من دون أن يحكم مباشرة، مدعوماً بقوة من عبدالناصر، ولهذا كان لا بدّ من تصفية أي احتمال ممكن لظهور قوى جديدة، أو حتى بقايا قوى قديمة، يمكن أن تنافس ذلك الصعود المتسارع في المدّ القومي العربي. ومِن مصر كان القوتلي يقود الحزب الوطني من بعد، ومصر ذاتها تغيّرت وذهب الملك فاروق وجاء الضباط الأحرار، وبرزت زعامة عبد الناصر، وحين رأى أن الظروف صارت مهيأة لرجوعه، قرر العودة إلى دمشق وأعلن ترشّحه لرئاسة الجمهورية، وكان قد ترشح ضدّه خالد العظم ولطفي الحفار الذي انسحب لصالح القوتلي، ليفوز الأخير برئاسة الجمهورية بـ91 صوتاً، فيما صوّت للعظم 42 فقط، وكلّف سعيد الغزي بتشكيل الحكومة.
وبقرار من رئيس حكومته، رفع القوتلي حظر بيع القمح السوري إلى فرنسا، فتظاهر السوريون المؤيدون للثورة الجزائرية واقتحموا وزارة الاقتصاد، واضطر الغزي إلى تقديم استقالته. ومجدداً، وجد صبري العسلي نفسه في مواجهة صعبة، فقد كلّفه القوتلي بتشكيل حكومة عنوانها العريض التعاون مع خصومه البعثيين. نحن الآن في أواسط الخمسينيات، قبل انقلاب البعث في 8 من أذار/مارس عام 1963 بثمانية أعوام، ولكن وبسبب صعود البعث المضطرد، فقد تولى رئاسة المجلس النيابي حينها أكرم الحوراني، وحظي بوزارة الخارجية صلاح البيطار، وبوزارة الاقتصاد خليل كلاس. ونتيجة الخلافات الحادة في الرؤى كان معروف الدواليبي قد وجّه باسم “حزب الشعب” الدعوة لكافة التيارات السورية لتشكيل حكومة “قومية” وتأسيس “ميثاق قومي”، وأكّد القوتلي تلك الدعوة وطالب الجميع بتناسي الخلافات وتشكيل جبهة وطنية للتصدي للمؤامرات الخارجية.
وعلى ذلك وجه مجلس النواب الدعوة لجميع الأحزاب لتشكيل لجنة من 20 شخصية وطنية تتباحث حول الميثاق القومي، وأصرّ أكرم الحوراني على أن يتم تمثيل كل حزب بممثل واحد فقط لتقليص العدد، وتشكلت اللجنة وظلت تجتمع لأربعة أشهر، وتوصلت في النهاية إلى صيغة تضم ما تم التوافق عليه من “مقاومة” الاستعمار الغربي والصهيوني والأحلاف الأجنبية، والصلح مع إسرائيل، والمضي قدماً في تسليح الجيش السوري من المعسكر الشرقي، وفي مشروع الوحدة مع مصر، وشكّلت حكومة سمّيت بـ “حكومة التجمع القومي”، كما يوثق الدكتور غسان محمد رشاد حداد في كتابه “أوراق شامية – من تاريخ سوريه المعاصر 1946- 1966” الصادر عن مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية في عمان عام 2001. فاستمر الحكم وفق هذا الميثاق حتى العام 1958 وتم إخراج أصحاب الدعوة لتأسيسه منه (حزب الشعب والكتلة الدستورية)، أما الجيش السوري فقد كان يعيش صراعات قوالبها فكرية ودوافعها شتى، صانعاً مسار سوريا على مدى تلك السنوات الضاريات.
المدن